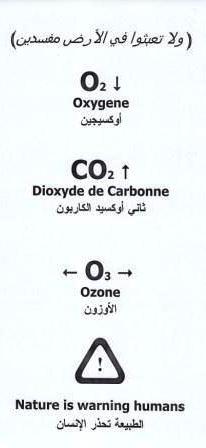العقيد القذافي - Page 28
بوش يكافىء القذافي... بـ"سيف الإسلام"
النهار – الثلاثاء 20 ك1 – 2003
بقلم: عبد الهادي محفوظ
تسعة أشهر من "الديبلوماسية الهادئة" بين واشنطن ولندن من جهة، وطرابلس الغرب من جهة أخرى، انتهت بإعلان الرئيس الليبي معمر القذافي عزمه على تدمير مواد أسلحة الدمار الشامل وتجهيزاتها والتخلي عن البرامج المتعلقة بالأسلحة الخطرة الممنوعة.
ومهما قيل في أن خطوة القذافي أتت في "سياق طبيعي" يندرج في "تعويض ضحايا لوكربي"، وفي المساعدة على الإفراج عن الرعايا الغربيين في الفيليبين، وفي "الابتعاد المدروس" عن الجامعة العربية في اتجاه افريقيا، وفي تطبيع العلاقات مع بعض أطراف المعارضة الليبية... مهما قيل فإن هذه الخطوة تقع أساساً في "لعبة المفاجآت" التي يتقنها جيداً الرئيس الليبي والتي شكلت سمة من سمات "عهده" التي جعلته اللاعب الوحيد حيث غاب عن المسرح السياسي أكثر شركائه في "الثورة الليبية" ليأخذ دورهم نجله سيف الإسلام الذي درس العلوم السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة الأميركية وتأثر بمفاهيم الليبيرالية الأميركية، ونجح في تقريب أستاذه الجامعي الدكتور شكري غانم من والده الرئيس فسماه رئيساً للحكومة قبل سنتين وهو صاحب الأطروحة الجامعية "ليبيا على أبواب القرن الحادي والعشرين" حيث لا تخفى حماسته للخصخصة والانفتاح والقطيعة مع إرث اللجان الثورية.
ست سنوات ونجل القذافي يروج لأفكار الانفتاح، ويتجول بين العواصم الغربية، لندن وباريس وروما وواشنطن وبون مبشراً بالتغيير المقبل على ليبيا. ونجح الابن أولاً في انتزاع ثقة والده وأصبح ممثله الديبلوماسي الأساسي لدى الغرب الأميركي والأوروبي. وهكذا قبل تسعة أشهر مهّد سيف الإسلام لحوار بين واشنطن ولندن وطرابلس الغرب، ونقل نية والده الخلاص من أسلحة الدمار الشامل، ورحب البيت الأبيض بالأمر إذ رأى في ذلك ما يخدم استراتيجيته الأمنية حول أسلحة الدمار الشامل. وإذا كانت المفاوضات قد بدأت في آذار الماضي وتوجت بزيارتين لخبراء أميركيين وبريطانيين إلى ليبيا: الأولى في تشرين الأول، والثانية في كانون اول، فإنها أفسحت المجال أمام خطوة القذافي التي جاءت في توقيت يعطي دفعاً غير عادي لسياسة الرئيس الأميركي جورج بوش في الشرق الأوسط. فهذه الخطوة لا يفهمها المراقب السياسي إلا كنتيجة لتداعيات الحرب الأميركية على العراق. ومن هنا الترحيب الشخصي المباشر للرئيس جورج بوش بخطوة القذافي. فسيد البيت الأبيض بعد سقوط النظام العراقي اتجه إلى تكييف أهدافه في المنطقة مع المتغيرات الناجمة عن بروز عنصرين متلازمين: المقاومة العراقية وعدم اكتشاف أسلحة دمار شامل عراقية. وهذا التكييف أخذ منحى الربط بين الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل. وقد جاء اعتقال الرئيس العراقي السابق صدام حسين وخطوة القذافي المفاجئة كنتيجة منطقية لهذا "التكييف" الذي يهمه أولاً استمرار تأييد الرأي العام الأميركي للسياسة الخارجية لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الحملة الانتخابية للرئيس بوش، وثانياً نقل الإرباك لموقف فرنسا وألمانيا وروسيا. وتحويله في اتجاه دعم نسبي للولايات المتحدة في العراق وتحديداً في مجال خفض ديون بغداد قبل الوصول إلى صيغة "المشاركة النسبية" المشروطة في منافع الاستثمارات الاقتصادية والنفطية.
وفي معلومات ديبلوماسية أوروبية أن تعجيل خطوة القذافي ناجم عن خشية الرئيس الليبي من أن يفشي الرئيس العراقي السابق صدام حسين للمحققين الأميركيين "الاتفاق السري" الذي حصل بين الاثنين عام 1999 حين حمل علماء عراقيون في مجال الذرة "برامجهم" إلى طرابلس الغرب ووضعوا علمهم وخبرتهم في تصرف العقيد وقطعوا شوطاً بعيداً في هذا المجال مقتربين من إمكان صنع قنبلة نووية. لكن واشنطن لا تؤكد هذه المعلومات وإن يكن خبراؤها فوجئوا بقدرات ليبيا النووية. فواشنطن تعترف في الكواليس بالدور القاطع لسيف الإسلام الذي استطاع أن يضمن "سلامة" النظام الليبي ويوحي صدقية الالتزام أميركياً، وكانت النتيجة مكافأة أميركية من الرئيس بوش أعلن فيها "استعادة الرئيس القذافي ليبيا إلى الأسرة الدولية" ووعده بمساعدته اقتصادياً.
لا شك في أن الموقف الجديد للرئيس بوش من الرئيس القذافي ومن النظام الليبي يحمل في مضمونه "قطيعة" مع "الماضي الأميركي" الذي كان يرى في الرئيس القذافي "أميراً للظلام" و"ديكتاتوراً" لا علاج له كما روجت أدبيات الرئيس الأميركي السابق رونالد ريغان الذي اعتبر الرئيس الليبي "ظاهرة" معادية للسياسة الأميركية ولحقوق الإنسان والديموقراطية. وواقع الأمر في الموقف الأميركي الجديد أن ثمة براغماتية واضحة تغلب المصالح الأميركية وتحديداً النفطية منها على مضامين "الخطاب الأميركي" الذي يغلف هذه المصالح بعناوين التغيير والانفتاح والديموقراطية والإصلاح وحقوق الإنسان. فأحد أسباب الانفراج الأساسية في العلاقات الأميركية – الليبية يبرز من الجانب الأميركي ضغوط شركات النفط التي تضررت في السنوات الماضية. وهكذا فإن المثال الليبي يمكن أن تفيد منه أنظمة توتاليتارية كثيرة.
وفي المقابل فإن "المعارضات السياسية" في هذه الأنظمة ستدرك أن واشنطن مستعدة لعقد مصالحة "مع الحكام في أية لحظة يقبل هؤلاء على "تنازلات" جوهرية.
ومع ذلك فإن من دلالات "الخطوة الليبية" غياب سياسة عربية واحدة تقرأ متغيرات السياسة الدولية ما بعد أحداث 11 أيلول. ولعل هذه الحقيقة هي التي تفسر عدم ربط الرئيس القذافي خطوته هذه بضغوط تمارسها واشنطن على إسرائيل في ما يخص ترسانتها النووية. وكل ذلك يدل على ضعف الوضع العربي بنيوياً، وقد تجلى ذلك في الآونة الأخيرة في القمتين المغاربية والخليجية. ومثل هذا الوضع ستكون له نتائج مباشرة تظهر في سعي كل نظام عربي إلى تحسين مواقعه الأميركية بمعزل عن الالتفات إلى أي قواسم وجوامع ومصالح عربية مشتركة.
أياً يكن الأمر فإن سيف الإسلام يفسر "الخطوات الليبية المتتابعة" بأنها استجابة لمنطق المتغيرات الدولية وبروز الولايات المتحدة الأميركية كدولة تتطلع لتكون "الإمبراطورية الرومانية الجديدة"، تضاف إليها حاجة ليبيا إلى تعددية سياسية وفكرية والإفادة من المنافع الاقتصادية والتكنولوجيا الأميركية، ومثل هذا التفسير يجعل منه "الوريث الشرعي" أميركياً لوالده الرئيس. وهذا ما لم يستطع إلى الآن توفيره الرئيس المصري حسني مبارك لنجله جمال.
إنما نجاح سيف الإسلام في "مبادراته الصامتة" المتعددة تبقيه متعثراً في "مبادراته الصامتة" المتعددة تبقيه متعثراً في ملف تغييب سماحة الإمام السيد موسى الصدر وصحبه الصحافي الأستاذ السيد عباس بدر الدين وفضيلة الشيخ محمد يعقوب. فإلى الآن لم ينجح في إقناع والده بكشف مسؤولية ليبيا، كما جرى في ملف لوكربي. فكل ما تطالب به عائلة الإمام هو كشف الحقيقة وإعلان الجهة الخاطفة ومعرفة مصير المخطوفين.(انتهى)
ــــــــــــــــــــــ